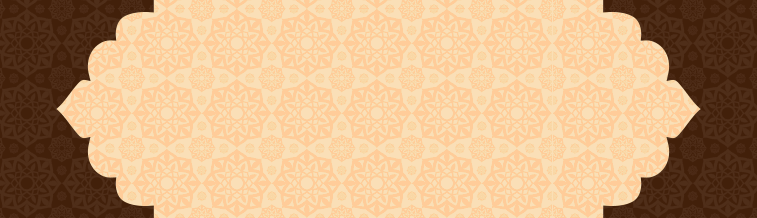تطرح ذكرى وعد بلفور مسألة التناقض بين دعاوى الغرب الديمقراطية وممارساته المنافية لإرادات الشعوب، ولهذا أردت وضع هذا الوعد في السياق العام لمدى التزام الغربيين بالديمقراطية في إطار سياساتهم الخارجية مع بقية الشعوب وهل يريد الغرب لها ما يريده لنفسه أم في الأمر أكثر من مكيال مرة أخرى؟
يثير اهتمام المتابع ما يبديه الغرب هذه الأيام من حرص على نشر الديمقراطية ولو بالقوة كما صرح بذلك وزير الخارجية البريطاني سنة 2008 ديفيد ميليباند، القدس العربي 13/2/2008، ومع اعترافي بعد القدرة على الإجابة عن سؤال محير هو كيف تكون الديمقراطية هي القبول بإرادة الشعوب ثم يراد فرضها عليهم بالقوة؟ فكيف يجبر الإنسان على ألا يكون مجبرا؟ وكيف تكون الديمقراطية هي إرادة المجموع ثم يكون تقرير هذا الأمر راجعا إلى شخص واحد كتوني بلير الذي يرى أن "قيمنا ليست قيما غربية، إنها قيم إنسانية وتصلح لكل زمان ومكان، ولدى الناس خيار واحد هو الإيمان بها" ليفن ص 178؟ أليس هذا التقرير في حد ذاته استبداد بالرأي ودعنا من التساؤل ماذا لو قال مسلم أمام العالم هذا الكلام عن قيمه ماذا كان سيحدث؟
مع كل ما سبق فإنه لا بأس من امتحان مدى صدق الغرب في التزامه بالديمقراطية تجاه بقية الشعوب من باب إلزام المدعي بما ألزم به نفسه وذلك في سبيل كشف إخلاصه في الطرح من عدمه وهل هو صاحب مبدأ أم صاحب غرض من دعواه.
في البداية نلاحظ مع ليسلي ليبسون في كتاب الحضارة الديمقراطية أن الاستعمار في العصر الحديث قام على أكتاف الدول الديمقراطية في أوروبا، ولسنا بحاجة إلى تحليل عميق لرؤية ما في هذا الأمر من تناقض واضح مع إرادات الشعوب المستعمَرة مما يضع علامات الاستفهام على مدى تضارب الديمقراطية مع الاستبداد الذي كان الاستعمار من صوره المتطرفة نظرا لاستناده إلى قوة تقنية متقدمة قياسا بالاستبداد المحلي الذي كانت الشعوب قادرة على إزاحته بثوراتها، وبخاصة أن دهاقنة هذه الديمقراطية الغربية أفتوا بأن الشعوب الملونة غير قادرة على حكم نفسها، كالأطفال تماما، وهي بحاجة لوصاية قد تمتد حتى تصل إلى سن الرشد، ومن ثم سحب الحق الديمقراطي منها بجرة قلم، ولم ير أحد في ذلك تناقضا مع الديمقراطية إلا ربما بعض الحالمين الذين لم تغير آراؤهم مسيرة الأحداث في الغرب، رغم ما "صادف" هذه الفتوى من مصالح كبرى كان الغرب يسعى للحصول عليها من سيطرته على بلاد العالم وسكانها وثرواتها ومقدراتها وإمكاناتها، ولننتقل إلى أمثلة محددة من التعامل الغربي مع الديمقراطية في السياسة الخارجية
أ- الاحتلال البريطاني لمصر: وضعت اتفاقية لندن سنة 1840 والتي أنهت الأزمة المصرية العثمانية بتدخل غربي، الأساس الموضوعي لوقوع مصر في فخ الديون الأجنبية التي تفاقم أمرها زمن الخديو إسماعيل مما أعطى الأوروبيين ذريعة للتدخل في شئون مصر بحجة استرداد أموالهم فقاموا بإجراءات تطورت من فرض مراقبين بريطاني وفرنسي على الحكومة المصرية (1876) إلى حشر وزراء أوروبيين في هذه الحكومة (1878)، وترافق ذلك مع الاعتراض على وجود مجلس نيابي وتحريض الخديو بهذا الاتجاه (1879)، ورفضت أوروبا أي اعتراض مصري على هذا التدخل أو أية محاولة مصرية لاسترداد وطنية القرار، ولما حاول مجلس النواب المصري استعادة السلطة على الميزانية المصرية سنة 1881 رفض الإنجليز والفرنسيون ذلك رفضا قاطعا حتى مع قبول المجلس الالتزامات الدولية لمصر وتعهده بحفظ حقوق الدائنين وحتى بتنازله عن النظر في نصف الميزانية المخصص لسداد الديون ثم بتنازله عن حق القرار ومطالبته بمجرد المشاركة فيه، ثم احتج الإنجليز والفرنسيون على الدستور الذي منحه الخديو في فبراير 1882 لأنه ينتقص من نفوذهم في مصر لصالح مجلس النواب الذي تكون الحكومة مسئولة أمامه مما يضعف هيمنة المراقبين الأوروبيين عليها، فأوروبا كانت تطالب بالسيطرة الكاملة على ميزانية مصر وفي سبيل ذلك وقفت ضد الديمقراطية التي تقتضي سيطرة الشعب على موارده وقراراته، ولما ثار الجيش المصري ثورة بدأت متواضعة المطالب ثم امتدت للمطالبة باستعادة السيادة مع السعي الجاد للمحافظة على العلاقات الودية مع الغرب بل والمحافظة على مصالحه في مصر والتعهد بحفظ حقوق الدائنين كان مصيرها السحق على يد الجيش البريطاني الذي دخل مصر واحتلها وارتكب فيها المجازر منتصرا للخديو المستبد الذي يؤمن المصالح الغربية على حساب الشعب وإرادته وكان أول ما قامت به سلطة الاحتلال هو إلغاء الحياة النيابية والدستور وتنصيب نفسها حاكما مطلقا وانتهى الأمر بتهميش الخديو الذي جاءت بريطانيا باسمه وبحجة دعمه سحقت الثورة العرابية وكانت تصر مع بقية أوروبا على "استقلاله" ولكن عن السلطان العثماني وليس عن الهيمنة الأوروبية مما جعله لقمة سائغة لاحتلالها، مما يثير تساؤل المراقب البريء وعجبه من كيفية اتفاق محاربة الحياة الديمقراطية وإلغائها مع الفكرة الديمقراطية التي كان الغرب يتبجح بها، إلا أنه سيفهم حقيقة الموقف أكثر عند اطلاعه على ما صاحب هذه الإجراءات من تبريرات وفتاوى استشراقية كوقوف الشعب إلى جانب الخديو، وهو ما سنراه في كل انتصار غربي لمستبد محلي في قابل الأيام، ثم إلغاء دور الشعب تماما برميه بالتهمة المعهودة استشراقيا وهي عدم الرشد وعدم القدرة على حكم نفسه ومن ثم حاجته إلى وصي عليه، ولم يكن في تصرف الديمقراطيات الغربية ما ينافي الديمقراطية في نظرها في كل ما سبق إلا ما ظهر من اعتراضات بعض المساندين الإنسانيين الذين صبت جهودهم العشوائية في النهاية لصالح الاحتلال في أسوأ الأحوال أو لم تنتج لشعوبنا أية نتيجة في أحسنها، تماما كما يتكرر التاريخ هذه الأيام
ومما يثبت التواطؤ الديمقراطي على الديمقراطية أن الفتاوى الاستشراقية لم تقتصر على البريطانيين الاستعماريين المنهمكين بشكل مباشر في مشروع الاحتلال البريطاني لمصر كاللورد كرومر الذي كان يرى أن الاستقلال المنشود للمصريين ليس هو أن يعيشوا كما يريدون بل كما يرى لهم الأوروبيون كيف يعيشون، تميم البرغوثي ص 51، بل تعدتهم لتصدر من شخصية أمريكية هامة في عصرها كالرئيس الأمريكي تيودور روزفلت الذي زار السودان ومصر بعد تركه منصبه سنة 1910 فمجد الاحتلال في خطبة في الخرطوم، محمد محمد حسين ج 1ص 111، ثم عرج على مصر في غمرة احتجاجات ومظاهرات مصرية ضد الاحتلال وألقى خطبة في الجامعة المصرية تضمنت تصريحات جارحة استفزت المصريين وكان مما قاله إن الأمر"سيتطلب سنوات وربما أجيالا كاملة قبل أن تتمكن مصر من الحكم الذاتي" وحث المصريين على التعاون مع السلطات البريطانية واصفا قادة الحركة الوطنية بمثيري الصخب والعاطفيين والضعفاء، أورين ص 313، ومن المفارقات أن بريطانيا التي كانت تنكر الديمقراطية على شعب مصر كانت تؤوي إليها معارضي السلطان عبد الحميد الذين يطالبون بالدستور في الدولة العثمانية وتشجع على مناوأتها في الوقت الذي كان السلطان يعمل ما في وسع دولته للارتقاء بشعبه وإيصاله إلى مستوى حكم نفسه بنشر التعليم في نهضة تعليمية أجمع مؤرخو المرحلة على ملاحظتها، في الوقت الذي كانت بريطانيا تهمل تعليم المصريين وتحضيرهم للحلول محلها في حكم مصر، شو ج 2 ص 195، والغريب أن معارضا عثمانيا للسلطان عبد الحميد يعد من المصلحين كولي الدين يكن، وكان لاجئا في مصر تحت الحماية البريطانية ولم يكن يكف عن الشراب مما تسبب في سقوطه كما وصفه الشيخ محمد عبده، النفزاوي ص 106 حيث أشار إلى تعاطيه الأفيون كذلك، كان هذا "المصلح" لا يكف عن انتقاد الاستبداد الحميدي في الوقت الذي يهزأ ويعارض مطالبة الشعب المصري بالدستور حيث يحكم الاستبداد البريطاني المحتل، محمد محمد حسين ج 1 ص 125، وهو ما يشير إلى أن تبعية المتغربين لا تقتصر أحيانا على ترديد أفكار الغرب بل تتعداه إلى تبني مصالحه ولو على حساب أمتهم ومصالحها.
ب- الغدر بالثورة العربية سنة 1916: كان الحلفاء أثناء الحرب الكبرى الأولى يخططون لتفصيل عالم ما بعد الحرب على مقاس مصالحهم بمعزل عن رغبات الشعوب الضعيفة والمهزومة وهذا رغم الشعارات البراقة عن التحرير وحق تقرير المصير التي رفعوها ضمن دعاية الحرب والتي تبين أنها ستطبق حيثما تتوافق مع مصالح الدول الكبرى المنتصرة بشكل انتقائي لا يشمل الجميع وذلك بحجة المرونة والواقعية وعدم التشدد في التطبيق، ويبدو من اعترافات شخصية هامة كالضابط البريطاني لورنس الذي قاد ثورة العرب على الدولة العثمانية وعلم بخيانة الحلفاء لهم عندما وصله خبر الاتفاقيات السرية التي تقتسم بلادهم بين الدول الكبرى، يبدو من اعترافاته مدى الازدواجية التي كان الغربيون يتصرفون بها في تعاملهم مع الآخرين، فمن جهة كان يعلم أن الوعود التي قطعها الإنجليز للعرب"في حالة كسبنا الحرب، ستبقى حبرا على ورق، وهكذا كان عليّ، لو كنت مستشارا شريفا، أن أنصح رجالي (العرب) بالعودة إلى ذويهم وديارهم عوضا عن المخاطرة بحياتهم في سبيل قصص وخداع من هذا النوع" ص 187 من أعمدة الحكمة السبعة، ولكنه من جهة ثانية لم يقم بذلك لأسباب نفعية وذلك طمعا في الاستفادة من المجهود العربي في الحرب ولأنه "لو أقدمت على البوح بما أريد لخنت رؤسائي البريطانيين" ص 146 ولهذا أقنع العرب بأن بريطانيا ستنفذ وعودها رغم "شعور مرير بالخجل لعلمي بأن ما قلته لا قيمة عملية له" ص 187، وظلت مشاعر لورنس موزعة بين الشرف والإخلاص لبلده فأرضى ضميره باللجوء إلى إقناع نفسه وإقناع العرب بأن تنفيذ الوعود البريطانية مرهون أولا وهو الأهم بتقديم "عون فعال للإنجليز" في الحرب، ص 354، هذا لإرضاء سيفه وإخلاصه لرؤسائه البريطانيين، أما ثانيا ولإرضاء قلبه، فهو بما يبديه العرب من قوة في فرض مطالبهم بعد الحرب، ص 315، وهذا كاحتلال الشام ومنع بريطانيا أو أية دولة "من تنفيذ مشروعاتها الاستعمارية الاستغلالية في غربي آسيا" ص 83، ويتساءل المراقب المحايد من أين أتى لورنس بهذه القوة للعرب لتطبيق هذا البرنامج وأين رآها وكيف حكم بإمكان أن تقف في وجه دول كبرى وهل كان يتكلم انطلاقا مما يراه فعلا أم من خيال واسع كان عليه مجرد إرضاء ضميره المعذب من الغش والخداع والمخاتلة والنفاق واللصوصية التي يرتكبها ووصمت خطط بريطانيا تجاه الثورة العربية كما قال هو بنفسه، ص 186 و316 و350 و351 وهو على العموم يعترف بلجوئه إلى "اللباقة" في الإجابة على أسئلة العرب الحائرين من تناقضات الإنجليز، ص 355.
والغريب أن لورنس الذي يدعي عذاب ضميره مما بيت للعرب نراه في تقاريره السرية عن الثورة العربية لا يخفي أهدافه وأهداف بلاده في إلحاق الأذى بالمسلمين عموما والعرب خصوصا ولا يرى في الثورة العربية إلا أداة لتحقيق أهداف بريطانيا في "تفكيك الجبهة الإسلامية الموحدة" نايتلي وسيمبسون ص 60 و"القضاء على خطر الإسلام بتمزيقه من الداخل" وذلك بإثارة حرب دينية بين الخلافة العثمانية وخلافة عربية في مكة يدفعها الإنجليز نحو العنف، ص 70- 71، وتحويل العرب بعد إزاحة العثمانيين إلى حالة من "الشرذمة السياسية، نسيج من الإمارات المتحاسدة غير القابلة للتماسك" ص 61.
فأين الديمقراطية من كل هذه الفوضى التي ما زالت تحكم بلادنا كما خططت لها بريطانيا منذ تلك اللحظة؟ وهل على هذا الأساس تبع العرب الغرب سنة 1916؟ وهل كانت هذه هي إرادتهم؟ أم الحرية وتأسيس دولة عربية مشرقية موحدة؟
ج- إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين: وكما أدرك لورنس تعارض الخطط الغربية مع إرادة العرب أدرك زعماء الغرب تعارض خططهم لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين مع رغبات الشعب الفلسطيني وهذا رغم كل الشعارات البراقة التي ادعوا فيها ما سيجلبه هذا المشروع من فوائد للبلد والمنطقة كلها، هذه الشعارات التي لم تكن أكثر من محاولات التفافية على صلب الموضوع وهو الرفض الفلسطيني العام لمشروع الوطن القومي، ويمكننا أن نطلع على تصريحات ساسة الغرب الذين دعموا هذا المشروع لنطلع على مدى اهتمامهم بالديمقراطية عندما تقف في وجه المصالح، من ذلك ما قاله اللورد بلفور، صاحب الوعد الشهير، في مذكرة سنة 1919: "إن القوى العظمى الأربع (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا) قد انحازت إلى الصهيونية، وسواء كانت الصهيونية صوابا أم خطأ، خيرا أم شرا، فإن جذورها تمتد في تقاليد عريقة، وفي حاجات قائمة، وفي آمال مستقبلة، ذات أهمية أعمق بكثير من الرغبات وألوان الحرمان التي يشعر بها سبعمئة ألف عربي يسكنون اليوم هذه الأرض القديمة" جارودي ص 345، وهو اعتراف هام يؤكد أولوية المنفعة، أو الحاجات القائمة بتعبيره، على الديمقراطية، ومن العجيب أن يتمسك سياسي علماني عقلاني بأساطير دينية ويصفها بالتقاليد العريقة بل ويقدمها على التفكير العلمي وتقاليد النهضة الغربية، وما ذلك إلا بسبب المنفعة قطب الرحى في هذه التقاليد، ويكمل بلفور مذكرته بالاعتراف أيضا بتناقض الصهيونية مع إعلان بريطانيا وفرنسا في نوفمبر 1918 أن هدفهما تحرير الشعوب من اضطهاد الأتراك وإقامة حكومات قومية تستمد سلطاتها من الشعوب، وبتناقضها كذلك مع الوعود التي بذلت للشريف حسين.
وفي حديث لبلفور سنة 1919 قال إن مبدأ تقرير المصير لا يصلح للتطبيق على جميع الشعوب وإنه لا يقر تطبيقه بلا تمييز، وإنه لا يصلح للتطبيق في فلسطين لأن العرب أغلبية ساحقة فيها، ولأن هذه الأغلبية لا تعجب السيد بلفور، فقد اقترح تأليف أغلبية من صنعه بالقول إن أي استفتاء على مصير فلسطين لا بد أن يشمل يهود العالم، وبهذا التزوير الذي لم يجرؤ عليه أعتى المستبدين العرب فيما بعد، ستسفر نتيجة الاستفتاء عن أغلبية كبيرة تطالب بتطويع فلسطين للصهيونية تحت حكم الانتداب البريطاني، الخولي ج 2 ص 21.
أما الرئيس الأمريكي "المثالي" ويلسون الذي أعلن حق الشعوب في تقرير مصيرها في محاولة للمزايدة على شعارات الثورة البلشفية، ورفض الاتفاقات السرية، فقد تراجع عن شعاراته عند التطبيق الذي أظهر أن هذه الشعارات ستطبق فقط عندما تخدم المصالح الاستعمارية وذلك لإزالة السيادة الإقليمية للدول العثمانية والألمانية والنمساوية عن أراضيها، ولهذا لم يعترض على استيلاء الحلفاء على البلاد التي كانت خاضعة لأعدائهم ومن ذلك تأييده الصهيونية التي لم يكن خافيا آنذاك تناقضها مع حق الشعب في فلسطين بتقرير مصيره، ميخائيل سليمان ص 59 و61، ومع ذلك كان صدور وعد بلفور بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة، ص 57، ثم تعهد ويلسون في رسالة للحاخام ستيفن وايز في أغسطس 1918 بأكثر مما منحه بلفور للصهاينة، ص 60، وأضفى الشرعية على الانتداب البريطاني على فلسطين ناظرا إليها من زاوية "المصلحة المادية" وليس من زاوية مثله المزعومة ص 59، وأُخفي تقرير لجنة كنج- كرين التي أرسلت لاستطلاع رغبات أهل المنطقة والتي أظهرت بوضوح معارضتهم لمشروع الوطن القومي وأبانت بحسم تناقضه مع حق تقرير المصير رغم أن أعضاء اللجنة جاءوا بلادنا وهم يحملون آراء مؤيدة للصهيونية ما لبثوا أن غيروها لاصطدامها بالواقع، ميخائيل سليمان ص 69، ورأوا في الادعاءات التاريخية اليهودية في فلسطين "دعوى لا تستوجب الاكتراث أو الاهتمام" الموسوعة الفلسطينية ج 3 ص 690، وفي محاولة إرضاء ضمير قام بها ويلسون بعد مغادرة المنصب أجاز نشر تقرير اللجنة بعد فوات الأوان، كما أرضى لورنس ضميره من قبل.
ومع أن الانتداب ادعى الوصاية على الشعوب لتهيئتها لحكم أنفسها، فقد أحجمت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين عن إقامة حياة ديمقراطية فيها خوفا من أن تعرقل سياسة الوطن القومي الذي يرفضه شعب فلسطين، وكانت تتحايل على ثورات شعب فلسطين ومطالبه بتقديم عروض بإقامة مجالس مقيدة بصك الانتداب وسلطة المندوب السامي وإرادة ملك بريطانيا، وتحاول فرض المساواة في الأصوات بين الأغلبية العربية والأقلية اليهودية، وكان الشعب يرفض هذه العروض الالتفافية لأن من شأنها تكريس ما يرفضه ويصر على طلب حكومة مسئولة أمام مجلس نيابي وفق النسبة العددية وهو ما يمكن أن يعصف بمشروع الوطن القومي إذا مثل السكان وإرادتهم تمثيلا حقيقيا حين كان العرب ما يزالون أغلبية ساحقة في وطنهم، ومن الطريف في هذا المقام أن بريطانيا الديمقراطية أنكرت التمثيل على شعب فلسطين في حين تمتع الفلسطينيون بهذا الحق في ظل "الاستبداد العثماني" فكان لهم نواب في مجلس المبعوثان في الآستانة، الخولي ج 1 ص 556 وهو ما طرحوه بوضوح أمام لجنة شو البريطانية التي بحثت أسباب اضطرابات سنة 1929 التي ذكرت أهل فلسطين بمقارنة عثمانية أخرى عندما كانت مقدساتهم تحظى بالحرمة ولا يجرؤ اليهود على انتهاكها كما فعلوا في حادث البراق في تلك السنة ج 1 ص 551، ثم استمرت المقارنات فأفادت اللجنة التنفيذية العربية في ردها على الكتاب الأبيض سنة 1930 أن البلاد المقدسة لم تكن تعرف الاضطرابات قبل الاحتلال البريطاني، ج 1 ص 573، كما ذكرت مذكرة اللجنة العربية العليا للجنة بيل سنة 1936 أن العرب كانوا يمثلون قطاعا هاما في الدولة العثمانية وقارنت بين وضعهم الممتاز فيها ووضعهم المتردد تحت حكم الانتداب البريطاني، ج 1 ص 613، وشارك المسيحيون أيضا في هذه المقارنة فقرروا أمام اللجنة المذكورة أنهم كانوا يتمتعون بامتيازات تحت حكم العثمانيين فألغتها حكومة الانتداب وأنهم كانوا ممثلين في المحاكم والمجالس البلدية والإدارية فتضاءل عددهم وأصبحوا على وشك الإقصاء النهائي، ج 1 ص 614، وغير ذلك أيضا من المقارنات الحزينة عن التطور نحو الأسوأ وقد اعترفت اللجنة في تقريرها أن العداء بين العرب واليهود لم يبدأ إلا مع الانتداب وأن العرب عاشوا في فلسطين عصورا طويلة مجردين من كراهية اليهود، ج 1 ص 647.
ومن المفيد هنا أن نلحظ موقف قطاع من المثقفين المتغربين الذين انحازوا للمصالح الغربية والصهيونية ضد أمتهم ومصالحها، فقد افتتحت الجامعة العبرية في القدس سنة 1925، وهي جامعة أقيمت على أرض عربية اغتصبتها السلطات العسكرية البريطانية من أهلها ومنحتها للصهاينة، وكان السلطان عبد الحميد قد رفض مشروع إقامتها من أساسه رغم المغريات التي قدمها له هرتزل ولعل أهمها أن تستوعب الشباب العثماني بدلا من ذهابه إلى الغرب وتأثره بالأفكار الثورية، ومع أهمية هذا العامل للسلطان فإنه لم يلق له بالا، الشناوي ج 2 ص 994، المهم أنه عندما افتتحت الجامعة بحضور بلفور واللنبي ووايزمان، كانت فلسطين تضرب إضرابا شاملا من أدناها إلى أقصاها مما دفع بلفور لاختصار زيارته وإلغاء مواعيده، ولما وصل دمشق ووجه بإضراب أشد عنفا ومظاهرات صاخبة وصدامات بين القوات الفرنسية والمتظاهرين أوقعت عددا من الشهداء مما دفع الوزير البريطاني للفرار مستخفيا إلى بيروت حيث وصل إلى البحر سرا وعاد إلى بلاده، الخولي ج 1 ص 551، وفي هذه الظروف نجد "أستاذ الجيل" أحمد لطفي السيد يشارك في افتتاح الجامعة العبرية مع دهاقنة الاستعمار مما نجد مشابها له إلى يومنا هذا من انحياز فئة من المثقفين إلى المشروع الاستعماري، وشاركه في هذا الموقف جريدة المقطم وصاحبها فارس نمر الذي لم يكتف بتأييد الاحتلال البريطاني في مصر بل تعداه إلى تأييد الحركة الصهيونية وتبني مواقفها والعمل على تغذية الوعي الصهيوني بين أفراد الطائفة اليهودية في مصر وغيرها من البلاد العربية كما يقول الدكتور حسن صبري الخولي في ج 2 ص 3، وكانت المقطم ترى في وضع فلسطين تحت حكم الانتداب ما لا يراه أهل فلسطين أنفسهم وتقارن بين حالة شعب فلسطين تحت حكم العثمانيين وحالته تحت حكم الاحتلال البريطاني بطريقة مناقضة لمقارنات أهل فلسطين التي مر ذكرها، وهو ما يشير بوضوح إلى انفصال الصحيفة وصاحبها عن قضايا الأمة وتبنيها مصالح الغرب بانحياز حاسم، ولم يغب الحضور "الإسلامي" عن هذا المهرجان وتمثل في صحيفة الكوكب التي أشرف عليها الشيخ محمد القلقيلي الأزهري وكانت تصدر عن المكتب العربي المنبثق عن دار المندوب السامي في القاهرة و"تدعو في غير حياء ولا مواربة إلى تهويد فلسطين" الخولي ج 2 ص 5.
وكانت النتيجة المنطقية لسياسة بريطاني في فلسطين نشوء دولة يهودية تعتمد ديمقراطيتها الممدوحة في الغرب كله على هويتها اليهودية الحصرية، التي تخالف الرفض العلماني لتصنيف الناس على أساس هويتهم الدينية، على استمرار معاناة وإقصاء شعب فلسطين من هذه الجنة الموعودة التي يكون مجرد حضوره فيها مناقضا ومدمرا لهويتها اليهودية الديمقراطية التي لا يرى الغرب فيها أي تناقض مع مبادئه المحيرة التي توفق فيه المنفعة بين المتناقضات، بل أصبحت هذه الديمقراطية اليهودية شرطا لحرمان الشعب الفلسطيني من الديمقراطية كما بدا واضحا من تهميش وقتل رئيس انتخبه هذا الشعب بأغلبية واضحة في سنة 1996، ثم في رفض الغرب نتيجة انتخابات 2006 التي أشرف عليها رئيس أمريكي ديمقراطي سابق لأنها جاءت بحكومة تعبر عن إرادة شعب فلسطين بعدم الاعتراف باغتصاب بلاده وهذا لا يروق للغربيين، ولهذا يتجاوز الغرب ديمقراطيته كما تجاوزها زمن وعد بلفور ويصر أن نكون كما يريد لنا أن نكون لا كما نريد نحن أن نعيش
د- إزاحة مصدق وإعادة الاستبداد الشاهنشاهي: اضطر الشاه محمد رضا بهلوي في سنة 1951 لتعيين الدكتور محمد مصدق رئيسا للوزراء نتيجة ضغوط شعبية ومظاهرات نظمتها قوى الجبهة الوطنية للمطالبة بالانتخابات الحرة وحرية الصحافة وتنفيذ القانون وتأميم شركة النفط البريطانية الإيرانية، آمال السبكي ص 185 وتمكن مصدق من إجراء إصلاحات عديدة تركزت حول تقليص سلطة الشاه مما اضطره إلى مغادرة إيران في سنة 1953، وفي البداية حاز مصدق على الرضا الأمريكي وأصبح بطلا في نظر الأمريكيين، أورين ص 495، وقارنته الصحافة الأمريكية بالرئيس توماس جيفرسون كاتب إعلان الاستقلال الأمريكي، ودعاه الرئيس ترومان إلى البيت الأبيض مساندا إياه في أحقيته في النفط الإيراني "مما أثار غضب بريطانيا" ص 495 أيضا، وتحرك الإنجليز للإطاحة برئيس الوزراء، واقتنع الأمريكان أنهم قد يخرجون من الصفقة تماما لو قامت بريطانيا بالمهمة وحدها، السبكي ص 192، ولهذا تعاونوا معها لفرض عودة الشاه مستغلين الخلافات الإيرانية الداخلية، وكالعادة صور الأمر وكأنه استجابة لمطالب الشارع الإيراني، ص 188، تماما كما كانت عودة الخديو توفيق "بتأييد" شعب مصر من قبل.
وبعد عودة الشاه والإطاحة بمصدق، فرض الأجانب مطالبهم وأوقف تأميم النفط ونالت أمريكا حصتها وعين الجنرال فضل الله زاهدي المعروف بكراهية الإنجليز لرئاسة الوزراء مما طمأن الأمريكان، ص 192، وأشرفت المخابرات المركزية والموساد الصهيوني على دعم عرش الشاه بجهاز السافاك الرهيب، ص 188، وبذلك وقف الغرب ضد ديمقراطية قومية علمانية وأعاد حكما استبداديا عاتيا بدافع حساباته ومصالحه الخاصة.
ومثلما فعلت بريطانيا بإيران تدخلت بالقوة والعنف لإسقاط رشيد عالي الكيلاني في العراق سنة 1941 رغم وقوف الشعب العراقي إلى جانبه بشكل غير مسبوق منذ ثورة العشرين، جيرمي سولت ص 147، وضرب الغرب التجربة الناصرية التي كان أغلب المصريين قد قبلوا بسياستها في تعويض الوقت الضائع في البناء على حساب حق المعارضة، ص 205- 206، ولم يستفت الغرب الشعب العربي في حل أزمة الخليج سنة 1990 كما أراد استفتاء يهود العالم في مصير فلسطين بعيدا عن رأي أهلها سنة 1917، بل فرض الحل العنيف وفق مصالحه وأيضا هنا صور الأمر وكأنه استجابة لرغبات شعبية، كما كان الغرب يدافع عن استبداديات غير شعبية في بلادنا لمجرد خدمتها لمصالح الغرب وفي خارج دائرتنا "كان يتم تصنيف عدد كبير من الديكتاتوريات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها على أنها جزء من العالم الحر" ليفن ص 183.
من كل ما سبق نرى أن الغرب يرى نفسه حرا في التعامل مع الديمقراطية في بلادنا أكثر من حريته بالتلاعب بها في بلاده، فعندما تقتضي مصالحه ينصب علينا مستبدين وتكون الجعبة الاستشراقية جاهزة للفتوى والتبرير بأننا غير راشدين أو يلزمنا أحقابا للنضج أو نطلب الاستبداد الذي يفصله لنا أو يتخذ من ضعفنا وسيلة لفرض خططه المناقضة للديمقراطية علينا كالاحتلال أو الاستعمار الاستيطاني، ولا يمنع هذا من استخدام الديمقراطية نفسها أداة للمصالح إذا اقتضت الظروف، والغريب هو القبول الغربي العام بعدم تعارض الديمقراطية مع هذه الممارسات التي "تتصادف" مع وجود مصالح يكسبها الغرب من مهمته "الإنسانية والحضارية" هذه.
والسؤال الآن: هل تغير شيء في الغرب بعد أحداث سبتمبر لنتوقع منه نصر الحرية وتأييد الديمقراطية كما يدعي؟
على الباحث عن إجابة هذا السؤال أن يجيب عن أسئلة أخرى قبله: هل يقبل الغرب أن تكون ثرواتنا بيدنا نتصرف فيها باستقلالية كما يتصرف هو بثرواته بعيدا عن التحكم والتهديد؟ وهو الذي يرى أن موقع النفط في بلادنا خطأ جيولوجي ينبغي تصحيحه؟
وهل يقبل الغرب أن تقرر شعوبنا مصيرها بحرية وتختار تنمية مستقلة بناء على تحكمها بثرواتها وتختار ما يناسبها من أشكال التنظيم الاجتماعي أم أنه سيضع خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه نحو حالة الوحدة مثلا كالتي تسود بلاده؟ وهل سيكف عن تقسيم بلادنا كما هو ظاهر من سياساته؟
هل سيقبل أن نطبق ديمقراطية حقيقية كالتي يطبقها في بلاده، أي أن نختار زعماءنا مثلا بلا تدخل من أحد كما يحصل هناك في الغرب؟ أم ان المسموح لنا هو مظاهر سطحية منها وإلهاء لنا بتوافه الأمور فقط؟
أعتقد أن ما أصاب العراق من ديمقراطية أمريكية بعد سبتمبر وما أصاب فلسطين من ديمقراطية الغرب والصهيونية يؤلف عبرة وإجابة عما يمكن لنا أن ننتظره، كما أعتقد أن الاعتقاد بتحول الغرب فجأة إلى البراءة الملائكية فيه إسراف في القول سيوقعنا من جديد فيما وقعنا فيه سابقا.
*****
المراجع
* الدكتور عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة
* الدكتور حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1973
* الدكتور جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط، ترجمة الدكتور نبيل صبحي الطويل، دار النفائس، دمشق، 2011
* الدكتورة آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين، سلسلة عالم المعرفة250، أكتوبر 1999، الكويت
* مايكل أورين، القوة والإيمان والخيال، ترجمة آسر حطيبة، كلمة، أبوظبي، وكلمات عربية، القاهرة، 2008
* ميخائيل سليمان (محرر)، فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كلنتون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996
* الدكتور تميم البرغوثي، الوطنية الأليفة، دارالكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2007
* رجاء جارودي، فلسطين أرض الرسالات الإلهية، ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين، دار التراث، القاهرة، 1986
* الدكتور محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مكتبة الآداب، القاهرة
* ت. إ. لورنس، أعمدة الحكمة السبعة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1979
* ألفريد سكاون بلنت، التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر، مكتبة الآداب، القاهرة، 2008
* تيودور رتشتين، تاريخ المسألة المصرية، ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمد بدران، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950
* أناتول ليفن، أمريكا بين الحق والباطل، ترجمة الدكتورة ناصرة السعدون، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008
* الدكتور محمد الناصر النفزاوي، التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية، كلية العلوم الإنسانية * والاجتماعية، تونس، ودار محمد علي الحامي، صفاقس، 2001
*الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، دمشق، 1984
* Philip Knightley and Colin Simpson، The Secret Lives of Lawrence of Arabia، McGraw-Hill Book Company، New York، 1970
* Stanford and Ezel Shaw، History of the Ottoman Empire and Modern Turkey، Volume 2، Cambridge University Press، 2002
المصدر/ التجديد العربي