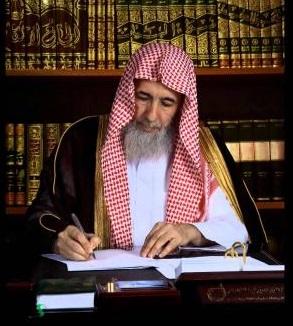
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن محن الأمة وتكالب الأعداء عليها مع قلة المعين وضعف الناصر من الناس، وهوان أهل الرأي السديد على كثير من الساسة، وتقريب هؤلاء أصحاب الآراء الفطيرة، بل تقريبهم أصحاب الآراء الخبيثة من الأعداء؛ اغتراراً بما يظهرونه من الصداقة والود مستترين باسم الوطنية أو الحضارة أو غيرهما، وغفلةً عن كتاب الله تعالى الذي أخبر بعداوتهم، وفضح بواطنهم، ثم صدق ذلك التاريخ؛ كل ذلك وغيره لا يخفى على بصير!
والمؤمن الموقن لو تدبر كتاب الله عز وجل لاستبان له السبيل، ومن أعرض عنه فلا غرو أن يعيش الضنك والضيق، وكثيراً ما يحدث ذلك شيئاً فشيئاً؛ فسنة الله الغالبة في الأمور التدرج، فالأشياء تحصل بأسباب، والنتائج تكون من جراء مقدمات، وكذلك تقلب أحوال الدول والممالك، ولهذا كثيراً ما لا يستفيق أهلها حتى تحكم القبضة من حولهم، فلا فكاك، وتصل الأمور إلى درجة يصعب بعدها العلاج.
وكثير من المصلحين الفضلاء العاملين يدرك هذه المعاني ويدندن حولها، فيكتنفه يأس فيغادر الساحة! أو يقعد ويكتفي بالمشاهدة، وبعضهم قد يرتكب حماقة تعوقه ثم لا تنفع الأمة، بل قد تضرها.
والواجب التوازن، فمع معرفتنا بسنن الله في الممالك والدول، علينا أن نستحضر سنته القاضية بحفظ الدين، وظهور أهله، ونصر أوليائه، وكبت أعدائه، كما قال سبحانه: {إنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْـحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} [غافر: 51]، وقال عز شأنه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْـمُرْسَلِينَ 171 إنَّهُمْ لَهُمُ الْـمَنصُورُونَ 172 وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات: ١٧١ - 173].
فإذا استحضرنا مع هذه السنن الواجب علينا، وعلمنا أنه ما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء(1)، وفي البخاري باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»(2)، وهكذا أدواء الممالك والأمم!.. إذا استحضرنا ذلك أيقنا أنه إذا أخذ المصلحون بالأسباب الشرعية، أظهرهم الله وكتب نجاة من شاء من الأمة على أيديهم، ومتى تخاذلوا وقعدوا عن الإصلاح، هلكوا جميعاً كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»(3).
وهذه السنن يجب أن تحكم رؤيتنا للأحداث من حولنا، وتحكم مع ذلك تصرفاتنا فيها، بل يتوقع العاقل النتائج بعد ذلك بناء عليها، ولا أعني بتوقع النتائج ظهور الدين ونصرة أهله في نهاية المطاف، فهذه ضربة لازب لا محيد عنها: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْـمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47]، {إن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ} [محمد: ٧]، {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} [الحج: 40]؛ لكن أعني ما تسفر عنه الأحداث من تغيرات سياسية، وما تؤول إليه أحوال أُسَرٍ وأمم، في الجملة.
ومن تمام فقه الداعية للسنن الماضية أن يعلم أن نصرة الله لدينه لا تقتضي أن تسير أمور البلاد على هوى الداعية أو رغبته، فينصلح الحال، وتستقيم أمور الدولة والناس على الشريعة! بل العامل لأجل الدين المخلص لله رب العالمين في عمله، لا يتعلق بالمسميات كثيراً، ولايأسف على ذهاب حكومة أو سقوط نظام أو زوال دولة لم تأخذ بسنن البقاء ولم تحفظ شرع الله ليحفظها الله، فخالفت المصلحين، وحاربت الناصحين الحادبين على أبنائها! وقديماً قال شعيب عليه السلام في بني وطنه، بل قبيلته وقومه، وقد أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ} [الأعراف: 93]! وقد قال الله تعالى لكليمه موسى لما ضرب التيه على قومه بني إسرائيل: {فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 26]، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: {فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 68]، {فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر: ٨]، بل أمرنا الله تعالى فقال: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْـمُجْرِمِينَ} [النمل: 69]، ثم قال: {وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} [النمل: 70]!
فالمهم ما يعمل المصلح لأجله، وهو هذا الدين؛ نجاة بالنفس واستنقاذاً لعامة المسلمين. أما نصر الله تعالى لدينه فمتحقق عاجلاً أو آجلاً، وأما استنقاذ المسلمين فموقوف على استجابة من استجاب منهم.
ثم على المصلح أن يستحضر وهو ينظر إلى أقدار الله ما يقوله في الصباح والمساء: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وإن كان المُقَدَّر مؤلماً، والخطب عظيماً! كما نراه جارياً في الأمة هذه الآونة.
فرضاه بالله رباً يقتضي رضاه بتدبيره لعبيده، عالماً بأن ما يجريه فيهم وإن كان مؤلماً فهو بحكمته تعالى البالغة ومن تمام عدله، بل يبصر الموفق رحماته تعالى ومِنَحه في طيات المحن، ويتدبر كيف يمكن أن تكون المصيبة لولا رحمة الله بعباده، فيحمله ذلك على اللهج بالثناء رضاً بالقدر، وعلماً بأن المصيبة المقدورة قد اكتنفتها رحمات، مع استحقاق العباد شديد العذاب! {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ} [النحل: 61]، وفي الآية الأخرى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ} [فاطر: 45]، {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [الشورى: 30]، وانظر إلى رحمة الله حيث يقول: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}!
ومِنْ رضاه بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن يحرص على سنته واقتفاء أثره ومتابعته أثناء القدر النازل، خلافاً لمن يتسللون جهاراً أو لواذاً من السنة عند نزول أدنى محنة! ففي مظاهر من التشبه بالأولى قالوا: {إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلَّا فِرَارًا} [الأحزاب: 13].
ومن رضاه بالإسلام ديناً أن يتعامل مع المصاب المقدور وفق شرع الله وأمره، فلا يتخذ من المصيبة ذريعة لمخالفة الشريعة! فالمصيبة ما وقعت إلا بذنب، والذنب لا يُرفع أثره بالذنب! وفي دين الله الذي رضينا به متسع وغناء، يعرف ذلك الفقيه النبيه، لا الغالي في دين الله، ولا الجافي عنه، والغلو والجفاء مخالفة لأمر الله وشرعه الذي جاء بالمصالح الدنيوية والأخروية، وفي خلافه ولو بالتأويل مفاسد على الأقل دنيوية؛ فالذي يسلك طريقاً غير صحيح لن يصل وإن كان قد يُعذر باشتباه الأمر عليه، وكذلك من خالف شرع الله بالتأويل، بل لو تأملنا ما أصاب الأمة من الحوادث الأخيرة وجدنا كثيراً منه بتأويل غلاةٍ هبُّوا لذود الظلم عنها، والدفاع عن حقوقها، فكانوا سبباً في تدميرها بجهلهم! وهم في مخالفتهم علماء الشريعة بين متأول مجتهد معذور - إن كان من أهل الاجتهاد - ومقصر أو صاحب هوى موزور له من إثم ما نزل بالأمة نصيب لتسببه فيه، وكذلك كثير من الظلم الواقع ابتداء كان بسبب تأويل الجفاة وفسادهم في البلاد أولاً؛ استبداداً وظلماً، وأكلاً للحقوق، وتحكيماً لغير الشريعة، وتقريباً لمن بعَّدهم الله، وتبعيداً لمن أمر الله بتقريبهم.
فالتصرفات غير المسؤولة غلواً وجفاء سببٌ في إيجاد فرصة للأعداء يتكالبون من خلالها على الأمة ويمررون المؤامرات ضدها.
وأهل السنة والجماعة بين الغلاة والجفاة، يعرفون الحق، ويرحمون الخلق، وينفون عن دين الله تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، ولا تقذف حماقات الغلاة أو الجفاة في نفوسهم اليأس من إصلاح الأحوال، ونصرة الدين، موقنين بقول إمامهم صلى الله عليه وسلم: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(4)، و«لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(5)، وفي حديث عمير بن هانئ رحمه الله أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشأم، فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم بالشأم(6).
وهذه الطائفة هي الباقية المنصورة؛ إن قتل منهم قادة خلفهم آخرون، وإن ذهب منهم إلى الله قوم أبدل الناس غيرهم، يعرفون أن المعركة معركة عقيدة، لا انتصار للأمة فيها بالتخلي عنها، ولا بموالاة أعدائها، أو ممالأة المخالفين لشريعتها، بل بالبراءة منهم، ومن مناهجهم، وهم مع ذلك يتّبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن سياسته للأمور، فيعملون بالمقدور، ويخففون على الأمة من الفساد ما استطاعوا، ولا يحمّلونها فوق طاقتها، أو يكلّفونها شططاً، يواجهون حيث كانت المواجهة خيراً للأمة أو لا بد منها، ويكفون حيث كانت المصلحة في الكف أو المسالمة والصبر.. يرحمون إخوانهم ويعطفون عليهم، ويغلظون لعدوهم المحارب ما أمكنهم، دون استعداء للمسالمين، أو تهاون مع المحاربين: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: 54].. يبذلون جهدهم على كافة الأصعدة لنصرة الدين؛ علماً وتعلماً، قولاً وعملاً، دعوة وجهاداً، صابرين مصابرين مرابطين، متقين الله فيما يأتون أو يذرون، وأولئك هم المفلحون، الذين تظاهرت النصوص على ظهورهم، فمن رام النجاة فليلحق بركبهم، وليسلك منهاجهم، في العلم والعمل، وليأت من ذلك بما يستطيعه، فإن تزاحمت عليه الأمور فليأت ما هو أولى، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان، فمن الناس من يكون بذلُ وسعه في العلم هو الأولى في حقه مع ضربه في بقية أبواب الخير بما تيسر له، ومنهم من يكون بذلُ وسعه في الدعوة أو الجهاد أو العمل هو الأولى في حقه، مع لزوم مشاركته في بقية الأبواب بما يتيسر له.
والمهم ألا يستعجل السالك، وأن يعلم أن الطريق طويل، والعقبة كؤود، تحتاج إلى توافر الجهود، وأن نصر الله عز وجل لا يأتي إلا بعد ابتلاء وتمحيص للصف يفتضح فيه المنافقون والمتهوكون، ويظهر للعيان ضلال الجفاة، ويستبين الناس فيه ضرر الغلاة وما يجرونه من الفساد، فإذا ظهر ذلك وسلك الناس الجادة، ونشأت أجيال قد عرفت طريقها؛ جاء نصر الله عز وجل، وفي أثناء ذلك سييأس أقوام وينقطع آخرون، ويظنون بالله الظنون! ولا غرو، فقد قال الله تعالى: {حَتَّى إذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْـمُجْرِمِينَ} [يوسف: 110]، وقال في خير أمة: {إذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْـحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا 10 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْـمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا} [الأحزاب: 10- ١١]، {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْـجَنَّةَ وَلَـمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214]، {الچـم 1 أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 1 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: ١ - ٣].
وأختم الكلام ببشارة نبوية ثبتت في الصحيح قالها صلى الله عليه وسلم في أوضاع أحلك من هذه الأوضاع، كان المسلمون فيها قلة، يسامون العذاب، ولم تكن لهم بالجهاد طاقة، بل كان في حقهم محرماً لأمرهم بالكف! في البخاري عن خباب بن الأَرَتْ رضي الله عنه قال: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(7).
إن المكر كبارٌ، والخطب عصيبٌ، لكن الأمر كما قال الله تعالى لسلفنا الأولين: {وَإن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [آل عمران: 120]، فعلينا بالصبر الإيجابي المقتضي للعمل الدؤوب وترك الاستعجال.. عافى الله المصلحين وسائر المؤمنين من التنازل أو الاستعجال، ومن الإياس والقنوط، وألزمنا وإياهم جادة الصواب بتوفيقه ورحمته.
_______________________
(1) صحيح مسلم (2204).
(2) صحيح البخاري (5678).
(3) صحيح البخاري (2493).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (3640).
(5) صحيح البخاري (7311).
(6) صحيح البخاري (3641) و(7460).
(7) صحيح البخاري (3612).













